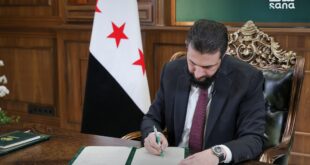محمد الحمد
كل ساعات اليد التي امتلكتها في التسعينات، خلال طفولتي، كانت ساعات رقمية تدور في فلك ساعات كاسيو، لكنها لم تكن يابانية ولم تكن مضادة للماء، كما أنها تفتقد إلى الجودة وأسباب الصمود والتصدي. فيبدأ التصليح منذ الأسبوع الثاني وتكون قد ودعت المونديال خلال أقل من شهر. وكان ثمن هذه الساعات خمسًا وسبعين ليرة سورية، فيما تبلغ قيمة كاسيو ستمئة ليرة أو أكثر. كنت أحسد أصحاب ساعات الكاسيو وأسأل نفسي: هل ياترى يشعرون بقيمة ما في أيديهم؟ أم أن الأشياء تفقد بهجتها حين امتلاكها؟ ما هي أمنياتهم أصلًا إن كانت لديهم ساعات كاسيو؟ ثم ما هذه الطفولة الخالية من هاجس الكاسيو؟ ألا يشعرون على الأقل بنعمة غسل أيديهم وهم يرتدون الساعات دون خوف من أن يفسد الماء أوقاتهم السعيدة أو الصعبة على حد سواء؟
اسم ساعتي المقلدة كان “أكوا”، حسب ما أذكر. ونظرًا لكثرة التصليحات التي تحتاجها، صار عندي خبرة في الفك والتركيب والتعديل على النابض الصغير الذي يثبت الحزام بعلبة الساعة. وذات مرة، عندما فتحت زجاج الساعة، خطرت لي فكرة ساذجة أول الأمر وهي أن أكتب “كاسيو” فوق “أكوا”. تطورت الفكرة فيما بعد إلى البحث عن ساعة كاسيو معطلة وأن آخذ الزجاجة الأمامية مع ما تحتها من كتابة “كاسيو” و”WR” و”WATER RESIST”.
سألت أمي عن ساعة كاسيو معطلة بين الكراكيب فقالت لي: “بالله عليك، ساعة كاسيو تتعطل؟”
لم يكن حلمي بسيطًا بل كان مركبًا. فقد كنت أريد ساعة كاسيو، أريدها من منبج تحديدًا، وأريد أيضًا أن يسألني الناس: “شقد الساعة معلم؟” وأريد أيضًا، وبشكل غير مفهوم، أن تتعطل ساعة الكاسيو آخر المطاف.
مؤخرًا، في السويد، حققت جزءًا مهمًا من حلم طفولتي المتعلق بالساعات، فقد صارت عندي ساعة كاسيو جلبها لي صديقي من منبج. وخلع أطفالي الحزام فقمت بإصلاحه استنادًا إلى خبراتي السابقة. يمر الوقت فتزداد مخاوفي أن تتعطل ساعتي الكاسيو قبل أن يسألني أحد في هذه البلاد وفي هذا الزمان: “شقد الساعة معلم؟”.
 Alsharq News الشرق نيوز
Alsharq News الشرق نيوز