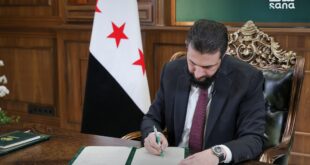أنور عمران
في صغري، كنت أقطع المسافات مشياً على الأقدام، فقط كي أرمي الحجارة على القطار الذي يمرّ شرقيّ القرية، أضحك كالملسوع حين تصطدم حجارتي بالحديد الذي يجري، وترتد كاللعنات عن القضبان المتوازية حتى حدود المجهول.. وربما كان اللاوعي يكره الإقامة، فيعاقب أولئك الذين تقمصوا الحلم ورحلوا، أو ربما كانت الفطرة تدرك أن الفراق هو النافذة التي تتسلل منها الريح السوداء، النافذة التي لا يُغلقها إلا الموت، فتستميت وهي تحاول أن تكسر زجاجها..
مع بداية الثورة السورية كنت قريباً من الأربعين، كنت هادئاً كمن ينتظر النبوة، ولم أكن أتذكر من القطارات إلا تلك القصيدة التي كتبتها في منزل القاص الراحل “أبو الخير البيريني”، والتي تتحدث عن قطار الرابعة فجراً كان يمر بالقرب من بيته، يصفر محمّلاً ببضائع غامضة، وتلاويح خفية، وكنا أنا وأبو الخير ننتظره بروحٍ هدَّها النعس والشعر.. وننتظره وكأننا نحمل التذاكر في قلبينا، ننظر إلى ساعتينا كمسافرين على عجل، ونقول: حان موعد القطار.. !!، ولكن في النهاية رحل صديقي القاص في قطارٍ لا أعرف وجهته، وبقيتُ وحدي أنوس بين آلاف القطارات..
وقبل بداية الثورة بسنوات، ومثل كل أبناء جيلي بدأت أركن إلى الحياة، وأحاول أن أبحث بهدوء عن نقوشٍ ملائمة لتابوتي الذي قطعت أكثر من منتصف الطريق إليه، حصلت على العمل الذي أحب، وكذلك المنزل والأصدقاء الذين كنت أتوهم أن سيوفهم في غمدي.. وفجأة قررت الملايين أن تتنفس، وكان لابد لها بعد هذا الاختناق الطويل والبغيض أن تتنفس .. كنت حينها في تلفزيون “الدنيا” والذي صار لاحقاً من أقبح أبواق النظام السوري، ضباط الأمن الذين كانوا يشرفون عبر هواتفهم على كتابة نشرات الأخبار بدلاً من المحررين، بعض الزملاء الصحفيين الذين بدؤوا يحملون المسدسات أثناء الدوام الرسمي، مفرزة الأمن الجوي التي سكنت في مدخل البناء، ووجه المذيعة – جارتي في المكتب- والتي قالت لي بوقاحة: إنها ستفرح إذا احترقت حمص ومات سكانها.. كل ذلك كان بمثابة الإشارة التي لا يقاربها الشك..” إنه موعدٌ جديدٌ مع القطارات”..
موعدٌ لا يفصلني عنه إلا تقريرٌ من أحد المخبرين لأن صوتي لامحالة سيهتف للحرية مع أبناء بلدي.
لمئات الأسباب، وبغض النظر عن الكيفية، وصلت إلى أوربا، وصار لزاماً علي أن أحرق ما بنيته وكل ما تعلمته، وأن أبدأ من جديد، ابتداءاً من رنين اللغات التي تتراقص حولي، ووصولاً إلى التعاريف الجديدة والغريبة لله والوطن والحب.. مكرهاً أحرقت مراكبي، ولكنني، مع ما أجره خلفي من السنوات والمفاهيم كنت كمن يعيش على الشاطئ فقط، ويخشى أن يتقدم خطوة نحو اليابسة، أو ربما يجهل أكثر مما يخشى..ودائماً كان عليَّ أن أُفسِّرَ للآخرين: لماذا أنا هنا؟؟
القطارات في أوربا كثيرة، كثيرة ومبحوحة، والصبيان هنا لا يشتهون أن يكسروا زجاجها، ولا حتى يلتفتون إليها، وأستغرب كيف بإمكانهم أن يكبروا دون أن يقولوا وداعاً ولو مرة واحدة لقطارٍ ما.. دون أن يمسحوا ذلك الغبش الذي يعتلي زجاج الشبابيك الراكضة.. وحدنا نحن المهاجرين، نتأمل القطارات بعيون صحراوية، ونسمع في عميق أرواحنا ذلك الصفير الذي لا يُقال أبداً..
ثمة قطار آخر، قطار خفي، يستقله أبداً أبناء جيلي الذين وصلوا إلى أوربا، قطارٌ لا يمكننا أن نغادره للحظة واحدة.. هو ذلك النوسان الذي يدفعنا إلى الماضي أكثر مما يدفعنا إلى الغد.. لو أننا أصغر قليلاً كنا نحتنا أسماءنا هنا، ولو أننا أكبر قليلاً كنا تسلينا بكتابة أغنيات الوداع.. ويرنُّ في روحنا السؤال ذاته الذي يسأله الآخرون: ما الذي نفعله هنا؟؟
 Alsharq News الشرق نيوز
Alsharq News الشرق نيوز