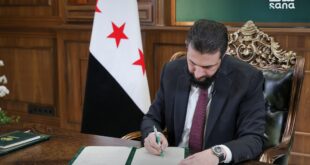الرئيس لا يحتاج إلى مَن يُصفق … بل إلى مَن لا يُجيد الرقص أصلاً
أحمد السالم
في بلادٍ تحترف التصفيق، وتُصدّر الطبول أكثر من القمح، يبدو الحديث عن دعم الرئيس دون تزويقٍ أو تزلّف، أقرب إلى رقصة فلكلورية فوق أرض ملغومة. لكن الحق يُقال – حتى لو أتى على لسان مهرّج في سيرك سياسي – إن الرئيس لا يحتاج إلى طبّالين، بل إلى عقلاء لا يتقنون النفاق، ومستشارين لا يُجيدون التصفيق، ومواطنين لا ينتظرون “المكرمات”.
المسألة لم تعد لعبة كراسي موسيقية، ولا مسرحية يُعاد عرضها مع تغيير الستائر فقط. نحن أمام لحظة مفصلية، حيث العالم يُعاد ترتيبه، بينما نعيد نحن ترتيب نشرات الأخبار، وننقل الكراسي من زاوية إلى أخرى، ونقنع أنفسنا أن هذا هو “الإصلاح”.
الرئيس – وهو على ما يبدو، يعرف جيدًا حجم المعركة – لا يطلب منّا حنجرة، بل شرايين. لا يريد مَن يُردّد “بالروح بالدم”، بل من يُنقّي الروح ويُصلح الدم الفاسد في شرايين الدولة.
لكنّ المصيبة، أن معركة الرئيس الكبرى ليست مع أعداء الخارج، ولا حتى مع خصوم الداخل، بل مع “صقور العتمة” الذين يرتدون بدلات رسمية، ويجلسون في المكاتب المكيفة، يُحاضرون بالإصلاح صباحًا، ويُجهضونه مساءً بتوقيع صغير أو تقاعس مدروس.
إنه التيار العميق… لا ذاك الذي يُنادي بـ”الدولة العميقة” كفزاعة، بل ذاك الذي يحيا داخل خلايا الدولة، يُراكم المنافع، ويَسِمُ كل محاولة تغيير بالتهوّر، وكل مبادرة وطنية بالتهديد لمصالح “القطاع الصغير” الذي أورثه السلطة والمال والمكانة.
هذا التيار لا يعارض، بل يُماطل. لا ينتقد، بل يُميت. لا يُهاجم، بل يبتسم ابتسامة باردة ويقول: “دعنا ندرس المقترح”. ولن تتم الموافقة أبدًا… لأن المقترح ببساطة، لا يمرّ من غربال المصلحة الضيقة، ولا يتماشى مع خريطة الولاءات التي تُدار بها مفاصل القرار.
الرئيس، على ما يبدو، يريد شركاء في المعركة، لا مهرّجين في الموكب. يريد من المثقف أن يكون مشاكسًا، لا مُصفقًا. من الضابط أن يكون حاميًا لا بلطجيًا. من الإعلامي أن يكون مرآة، لا مكبّر صوت. من القاضي أن يكون ميزانًا، لا موظف أرشيف.
لكن لا حياة لمن تُصفق طبولهم…
لأننا – ويا لسخرية القدر – لا زلنا نرى من يعتقد أن الدولة تُدار من خلال “رئيس مكتب”، وأن القضاء يُصلح بمذكرة، وأن الأمن يُبنى بحملة اعتقالات، وأن الاقتصاد يتحسن إذا قرأنا النشرة المالية بصوت جهوري.
ما زال هناك مَن يقول “أنا الدولة”، وكأن الجمهورية عَرَض جانبي في سيرة ذاتية. وهناك من يمارس السلطة وكأنها ملكية خاصة، يتصرف باسمها، ويوزع صكوك الوطنية كما تُوزع الهدايا في حفلات الزفاف القَبَليّة.
ولأن السخرية قدر هذه البلاد، فإنك قد تجد مَن يرفع شعار محاربة الفساد، وهو نفسه يطلب “المعلوم” قبل أن يختم أي ورقة. وتجد من يلعن الاستبداد، وهو لا يسمح لأحد أن يُقاطع حديثه في جلسة مغلقة.
في هذه اللحظة الحرجة، لا نحتاج إلى تلميع الرئيس، بل إلى خوض معاركه معه، ضد الذين يُديرون الدولة كأنها “ضيعة”، والمؤسسات كأنها “غنيمة”، والمواطنين كأنهم “رعايا”.
نعم، لا مكان بعد اليوم للمعتقلات الخاصة، ولا للولاءات التي تعلو على الدستور، ولا للخطوط الحمراء المرسومة حول الفشل باسم “الأمن”.
نعم، علينا أن نقف مع الرئيس، لا حبًا في صورته، بل لأننا نُدرك أن بديل هذا المركب الغارق هو الغرق الجماعي في مستنقع الفوضى، والاقتتال على طوق نجاة وهمي.
لكن الوقوف مع الرئيس لا يعني أن نحمله على الأكتاف ونطوف به في الساحات. بل أن نحمله المسؤولية، ونحمله على قول الحق، ونحمله على اتخاذ القرار الصعب، ونمنعه من مغازلة الحرس القديم مهما ارتدى من أقنعة.
فإما أن نكون شركاء في إعادة تأسيس هذه الدولة، أو شهود زور على جنازتها القادمة.
الخلاصة؟ الرئيس بحاجة لمَن يُقاتل معه، لا لمَن يُغني له. والأوطان تُبنى بالعقول لا بالمزامير.
والمستقبل… لا ينتظر مَن يُصفق.
 Alsharq News الشرق نيوز
Alsharq News الشرق نيوز